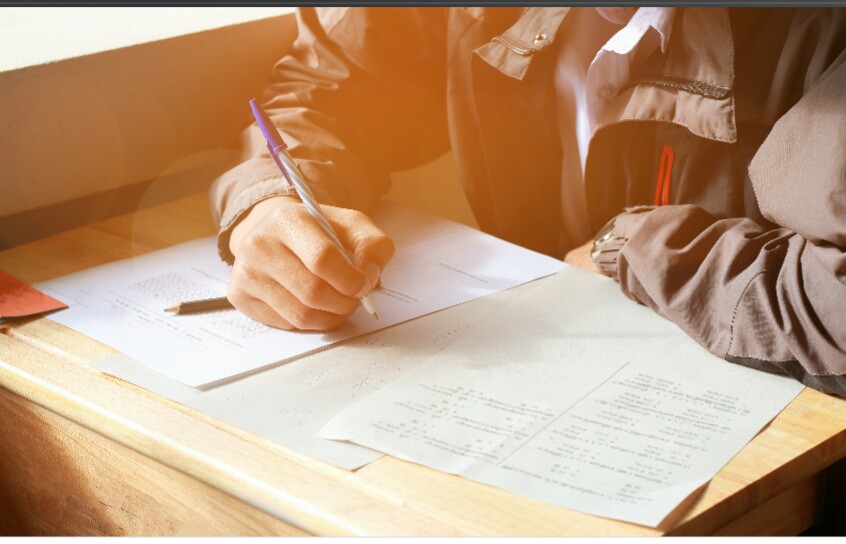
بنشاب : شباب هذا العصر في فسحة كبيرة (وفتنة لأهلهم)، واغلبهم لا يعلم ذلك او لا يعيه على مقدار حقيقته ودلالته. فهم في الإعداد والمراجعة، حملة هواتف والواح ذكية ملساء تسر الناقرين، بها كل موضوعات الدرس وارشيف الامتحانات. وبعضهم في إعدادهم للامتحان محمولون تسعة أشهر على الأكف، ومحمول بعضهم في فره الأرحام من وثير المقعد في السيارات اليابانية والالمانية المكيفة، ومتجندة لهم الأسرة وباذلة ماليا ونفسيا؛ كأنها تجهز ابنة لها - ذات عذر - اعياها البوار واكلتها آلة المجتمع المتروش تعييرا بالعنوسة، في عرسها الى فتى الفتيان المتأكِّس او المتفوِّت ذي المليار تركة، صاحب الشهادة في البرمجيات من هارفارد، وذي السمعة الطيبة الودود، مالك نيمروين خمسمائييْن "قرْنييْن" مخططا في قلب "الصكوك" بصك عقاري موثق، وقادم للتو من بوسطن، لا يرى عليه اثر السفر.
لقد كنا -جيل الثمانينات واول التسعينات- ترى الفتى منا - كحال المتكلم من هذه الصفحة - تراه يختلف يوميا من "سوسيم" قرب "امسيد المغرب" الى كثبان الو سي حيث ثانوية التطبيق (ملحق الجامعة لاحقا)، ثم بعد ذلك بعام نحو الثانوية الوطنية قرب الاذاعة ثم الثانوية العربية في فصل الختام الثانوي. كنا نذهب مرتين في اليوم وليس لنا من السلندرات غير اقدامنا، ولا من السائقين غير قوى الدفع الذاتي، ولا من المكيفات غير اكمامنا، وتكون شمس الصيف وظرف الصوم مجتمعين علينا، ومع ذلك كنا نجد وننال ولا نرهق اهلنا بدينار. رغم ذلك، كنا ننال المراتب ولا نكثر الشكوى؛ واذكر اني نلت في اولى ثانوي مثلا حين كنت في ثانوية التطبيق -وانا اقطن اقاصي غرب سوسيم - مثلا الرتبة ثانية في الامتحانين السنويين بتقدير "تشجيع"، ونجحت بعد ذلك مرتين متتاليتين في الباكلوريا في الدورتين الأولين (كان مسموحا حينها الاعادة بعد نيل الشهادة)، كل ذلك دون ان الزم اهلي غير معتاد المؤونة التي لا تتعلق بالدرس اصلا، او دفاتر اول العام (من النوع العادي عند دكان الحي، كدفتر الصاروخ مثلا) واقلام بيك (وبعض المتروك لاحقا المخفي آنذاك مما نُفِث وكيَّف من فئة peter stuyveseant و Lucky strike و Marlboro والأخيرة في الأعياد او ظروف اليسر)
بل إن الاغنياء وذوي المكانة منصبا على زمننا الجميل ذاك، لم يكونوا بهذه المظاهر الكرنفالية والدلع والبذخ لابنائهم، ليس لأنهم لا يهتمون بل لكونهم غير مفتونين مكرهين تحت ظاهرة اجتماعية فاسدة هي السائدة اليوم، وكان اغلبهم متمدنين مثقفين. فلقد عايشت مجاورة فصول دراسة في الثانوية الوطنية، رغم اختلاف الشعبة، الأختَ الطيبة الخلوقة زينب بنت معاوية، وكان ابوها معاوية الدمشق المحلي، تأتي بها R12 توروس ولا يرافقها مظهر بهرج خاص غير فرد عسكري سائق يبقى بمحاذاة الإدارة ليأخذها عند انتهاء الحصص، وأذكر للتاريخ ايضا انها لم تنجح تلك السنة وما سقطت السماء على الوزارة كسفا، ولم يتدخل الرئيس ليغير الوضع (والقصة وما جرى فيها موثقة في ارشيف عميد مفتشي التعليم الثانوي، وتشهد ان اباها لم يتدخل ولم يأمر بذلك وانها أعادت)
وفي صفي المباشر، اذكر أن أخي العزيز وزميلي العزيز - الدكتور حاليا - أحمد ول سيديا (طبيب مركز عرفات الرئيس حاليا، والمشاد به من طرف الأهالي هناك) كان يأتي غالبا ويمضي على الأقدام، ووالده الأمين الدائم للجنة العسكرية آنذاك، ويسعه تسيير موكب يومي ان شاء! وكان أحمد بيننا لا تحسبه ابن نافذ بساطة وخلقا وعدم تمظهر بسلطة والده التنفيذية وتفوقا بجهد وكبَد (أقول ذلك لمعايشتي له عن قرب صداقة وزمالة)، واذكر أني واياه وزميلا آخر كافأنا استاذُ الفرنسية في الاعدادية، الفرنسي "جيرار تيرpينه"، بجوائز تفوُّقنا وكانت نسخ حديثة جدا لقاموس "لاروس" الكبير (صاردة بطبعة سنتين قبل ذلك)، لا ازال اذكر بهجتها حين استخرجها لنا، ملفوفة بغشاء تعبئة ابلاستيكي شفاف، من صندوق سيارته ال R 6 برتقالية اللون امام البوابة الشرقية للاعدادية المقابلة للمعهد العالي للدراسات الاسلامية. كنا نتفوق ونكابد يومياتنا، ولم نكن على أهلنا ثقلا ونصبا كما هو حال الأسر اليوم، مع ان اهلنا يهتمون لشأننا ويؤدون كامل حقه؛ الفرق اليوم مسألة فساد نظم تربية وثقافة وموضة غبية ؤتوف!
جيل اليوم في فسحة مبطَّنة بفتنة له وكرب لأهله ومحيطه؛ فعلى ايامنا المجيدة البسيطة كانت المراجع المساعدة: بضع كتب من bordas بعضها مهترئ وناقص بضع صفحات من الجهتين، وربما بقيت في ثنايا صفحة منها رسالة حب مراهق من "جيل من قبلنا" كالتي ترون على الجدران مثلا :) او كَاف رومنسي مراهقي حالم (على نحو الأبيسوري هذا في لبير: للخاط مريم ما اتميل -- اخلاكِ وُلْهَ باكِ .... والمريم زاد ابلا اجميل -- لا مالت بعد اخلاكَ). ومع ذلك، اجاد جيلنا فن الممكن في ايجاد المراجع وفعَّل ميزة الذكاء والذاكرة (كان بعضنا اذا فاته درس واستحالت اعارة الدفتر، جلس فحفظ عن ظهر قلب ثم مضى، واخلاص).
لم نكن في فسحة الانترنت والتصوير السريع والواتساب وبابا ؤماما ؤتيته، بل كنا نلجأ احيانا للنسْخ باليد لما عز تصويره (يعني ببساطة خوي: عنك تكفت ركبتك ؤتوف وتنسخ بحبرك مرادَك وقد يصل حجم كتاب متوسط)، ونتداول كراريس جيل من سبقونا وكأنها برديات بها سر ماء الحياة وطريق الارشاد لمدينة اتلانتيس المختفية او كأنها "حجر رشيد" في فهم اللغة المصرية القديمة!
كنا نتلقف دفاتر المتفوقين والمجتهدين في تنظيم الدفاتر قبلنا وحسني الخط منهم، كأنها كتب الصحاح لطالب علم الحديث، والمحظوظ المحظي منا من وصل الى جهاز تصوير عمومي هو الحصري في نواكشوطستان خارج المكاتب الرسمية (عند شركة اكراليكوما قرب السوق، ابنعت الناس العام ؤقرب مطعم "سنبدباد" اص ابنعتنا نحن التركة؛ فلسنباد قصة لا يدركها ألا من تابع عنده فيلم "الرسالة" المعاد الف مرة، بأكله ساندويتشه على مهل تحايلا على مالك المطعم).
أرى اليوم فتيان كرتون وفتيات اسناب يحملن هاتفا براتب موظف عمومي عليه قواعد بيانات مليارية المحتوى، أراهم مقضبي الجبين عبوسين كأنهم خرجوا من كرب عظيم وحفروا للتو مترا في ردم يأجوج، لمجرد أن السائق لم يصلهم في الوقت المناسب أو لكون النت انقطع يوما، أو لكون جيش اساتذة الدرس الخاص غاب بعضه لمرض او تعزية؛ فأقول بلسان الحال، كنا نحسب هذا خيالا (النت) وترفا (السيارة والتوصيل) على ايامنا وليونة للفتيان تعيبهم حتى يتواروا من اترابهم!
لا شك أن للتغيرات التي مر بها المجتمع اثرا على هذا الشأن. فموجة المال السهل منذ التسعينات والثراء غير المبرر اقتصاديا في باب العمل والنصَب وموضة تسيد الجهال ثقافة وتمدنا، وكذلك كارثة التعليم الثانوي الحر ونزعة التجارة في التعليم، كل ذلك انتج حالة هي ما نتخبط فيه اليوم. فاستسهال المعايير وطغيان الوساطة وتشكل ثقافة اتفكَريش واتفركيش (court-circuitage) في النظم والضوابط، ومفاهيم ك"اتشعشيع" و"لبرود" (بالشق الذي يعنينا هنا)، كل ذلك القى بأثره على المُدخل التعليمي والمُخرج ايضا. كما ان تجارية التعليم الخاص ولغة الطلب والعرض جعلت الاستاذ رهينة لدى الطالب الذي يدفع فانهار ميزان التقدير واعان بعض الأساتذة في ذلك بتتبعهم مظان الدفع في الدروس الخاصة وتساهلهم في ذلك.
مثلا، كان الغش موجودا لكنه كان عيبا قادحا ومسبة للغاش والمعين عليه اداريا، وهو اليوم ظاهرة جماعية -لبعض الاساتذة فيها يد قابضة رافعة - ومتقبلة بقبول حسن مجتمعيا ومحل افتخار احيانا، بل موضة (لكون الموضة هي ما يفعله الاغنياء فيستحسنه الناس غالبا). صرتَ اليوم ترى الفتى المُنزِلَ سرواله، المضيق قميصه من الاجناب حتى أنت اضلاعه، المفحِّمَ بواكير ذقنه، الممتطي احدى الأسيات (كورولا s ايصانص) يصول ولا يجد حرجا في التبجح انه غش او غش له، لأن الأمر صار منبئا عن مكانة الشاب ماديا ووظيفة ابيه او امه منصبا!! لم يعد الغش مسألة اثرياء كسالى أو فقراء محبطين، بل مد الرداء الى الطبقة العامة في باب العدوى والتمظهر!
تماما كما استبيحت معايير اخرى كالاستحقاق الوظيفي، ومواد البناء ومواعيد الالتزام، وجودة الدواء، وحتى الجمال والارتباط؛ فصار سوقا للسنبشة والفتشبة والحشو البدني والملحمي، حتى خيف ان يخطب الخاطب الساذج الطيب "انجلينا جولي" من اهل شمامة امزيْدَة فلخريف ؤلابسة نص من النيلة، وهو في الواقع يخطب زميلة لصديق لنا مصري طريف زمن جاهلية الشباب و غربة الدراسة (حدثنا احد اصدقائه وكان بليغا ليصف حال الأخت تلك دون ثرثرة، فقال : هجيبلكم من الآخر؛ تقريبا اسمها عمر).
سلام على زمن الناسخين الدفاتر بأيديهم والمشائين في القيظ الى الفصول والمتفوقين في مدارس الغربة رغم جفاف الحال في الوطن.
،
(الصورة بتاريخ ستة اشهر بعد الباكلوريا، ملتقطة في حي طلبة سيتي طالب عبد الرحمن ببنعكنون، الجزائر)
#إلذاك




(2).JPG)





